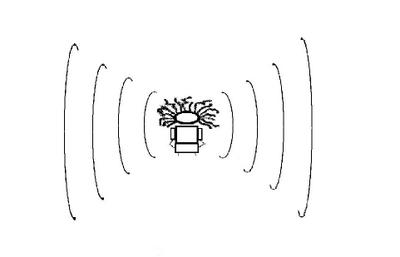cccc
تحدث طبيبي النفسي عن ذلك الإنسان الذي يعود من المجاعة ناسيا كيف يأكل. على الموائد المعدة للمصالحة يقيء لاإراديا. أعتقد أنني أقيء أيضا بأشكال مختلفة Subversiveness is neither cool nor adolescentالسبت، يوليو ١٦، ٢٠١١
ربنا موجود - قصة من وحي المنفى غير الاضطراري

في يوم مشمس كهذا قرر الله أن يخرج عن صمته ويتدخل في شئون عباده. لكنه ما لبث أن فطن بواسع علمه وعظيم جلاله إلى أن ظهوره على إحدى صوره المعهودة من قديم الأزل، لما يرتبط به لزاما من ترجيح كفة لغة وأمة وديانة على غيرها من المصرين اصرارا أعمى على انفرادهم بسره وأحقيتهم دون غيرهم في فائض علمه وغزير رحمته، كفيل ببث المزيد من الغمة بين الناس. لذا رأى جل جلاله أن يخرج على الناس في شكل كلمة بلا جسد وصوت غير مكلوم: على هيئة صفارة انذار.
في يوم مشمس كهذا خرج السيد شرايبر من منزله ليتنزه في الحديقة العامة غير البعيدة. كان قد خرج لتوه من نوبة اكتئاب عتية ولم يسمع بعد بما طرأ على الكون من تغيير. يمشي متعنطزا يضرب في الأرض ويختبر متانة نعل حذائه الجلدي الجديد. لولاه – لولا فرحته بشرائه وشغفه لاختباره – لما مرت النوبة بهذه السرعة. يقف لحظة ويخفض نظره إلى رجليه، يمسح بنظراته على الجلد الكستنائي الطري اللامع كمن يهدهد طفل رضيع. ياله من حذاء جميل. مائتا يورو سعر باهظ لكنها ليست خسارة في حذاء كهذا. يأخذ نفسا عميقا راضيا يملأ رئتيه برائحة الياسمين. يمضي إلى الحديقة كالماشي على وسادتين من ريش الأوز الناعم المنفوش.
فجأة. شكة في قلبه تعيد السواد إلى حياته. لازال كيانه هشا وعرضة للانهيار لأتفه الأسباب. يحتاج بشدة أن يصل إلى الحديقة ويفتح مسامه لشمس الربيع فتطهر ما ترسب بداخله من بلغم الحياة. لكن حصنه ينهار بسرعة وبعد دقيقة أخرى: لا سبيل للالتفاف على الحقيقة. تجحظ عيناه من وقع المفاجأة المؤلمة: هناك عيب لا يغتفر في الحذاء.
رقبة الحذاء الأيسر تكحت في كعبه الخارج. ليس بشكل مؤلم بالضرورة لكن مستفز بالتأكيد. يتسارع نبضه وتضرب السخونة في جسده وهو قابع مكانه في شلل مؤقت. بين مراكز عصبية مختلفة في دماغه حوار عنيف وشد وجذب. بعضها فطن إلى أن مصدر النغص احساس يضاهي في قوته وتأثيره ما قد تحدثه نملة تحمل منشارا ميكروسكوبيا من خراب في جزع شجرة كستناء معمرة. لكن... ليس السيد شرايبر الذي يتهاون مع الصغائر. فما باله بما قد يبدر منه سهوا من استسهال وسذاجة إلا وقد انقلبا عليه وتحولت التفاصيل الدقيقة على وداعتها إلى وحوش كاسرة وأورام سرطانية مستفحلة تلتهم كل مهمل بليد. لذا بدا له بعد ثوان قليلة من النزاع الداخلي أن الذهاب إلى محل الأحذية للمطالبة بنقوده أمر لابد منه.
والحقيقة أنه لولا انكفائه الشديد على ذاته وذبذباتها الدقيقة وتجاهله التام لما حوله لوجد السيد شرايبر – في هذه الأيام بالذات - في محيطه من دواعي الدهشة والسرور ما هو كفيل بتعزية حتى شخص مريض مثله. فلم يخلو وجه في هذه الأيام من ابتسامة ولو خاطفة، حتى باتت قسمات الوجوه بما تحمله من معان الرضا وصفاء النفس تضاهي أكثر مشاهد جبال الألب سحرا وخلابة. وكانت صفارة الإنذار تنبعث من مواضع مختلفة في محيط السيد شرايبر وتعلو على إثرها الضحكات والنوادر وتصفيق الأكف على الأكتاف في حميمية، لكن السيد شرايبر انشغل عنها ولو إلى حين.
وعندما دخل محل الأحذية كان هناك بائع جديد لا يعرفه فزاد ذلك من ارتباكه مثله مثل كل ما يشكل تهديدا لنمط حياته المألوف. البائع شاب طويل القامة نحيف يلبس بنطال أحمر محزق وفانلة بدون أكمام. كما أن وقفته مائلا بخصره إلى اليسار ساندا معصمه عليه توحي بألاطة غير مبشرة بالمرة.
"عفوا، أريد رد هذه..." قالها شرايبر وهو يدفع الكارتونة التي تحوي الحذاء عبر الكاونتر.
انقبضت أسارير الشاب وزفر في ضجر كمن يقول: "هذا كل ما كان ينقصني."
وفي بطء شديد بدي لشرايبر متعمدا فتح الكارتونة وأفرغها من محتواها، ثم أخذ يفحص الحذاء باهتمام.
"ماذا ينقصها؟"
تعجب شرايبر من السؤال فهو يتردد على المكان منذ سنين، واعتاد العاملون نزواته وشكواه التي قد تبدو غامضة، فجرت العادة على أن يجاروه مطيعين اختصارا للوقت.
قال متعلثما: "أريد ردها..."
"أعرف. لقد سبق أن قلت ذلك. على العموم أنا مضطر لرفض طلبك. عليها بعض الوسخ. يبدو أنك قد ارتديتها بالفعل..."
مع أنه قالها بنبرة لامبالاة، إلا أن وقع الكلمات على شرايبر كان كوقع صهيل خيول مغيرة على معسكر نائم في طمأنينة وسبات. أحس بهستيريا صارخة تتصاعد من أعماقه. كبس على أسنانه ليكبحها فخرج الكلام من فيه مضغوطا ثقيلا.
"وكيف... أجربها... دون أن ألبسها؟"
"كان عليك أن تجربها قبل أن تشتريها. أنا آسف. كم وددت ان أساعدك. لكن لا خيار لي."
في هذه اللحظة سمع صوت دوي شديد. ليس كصفارة إنذار تقليدية والتي تبدأ على مهل ولها صوت متثائب يتمطؤ في الهواء. بل أقرب إلى صفارة حكم، قصيرة ومضغوطة وقوية، تعلن عن نهاية شئ ما. شرايبر وضع أصابعه في آذانه بحركة تلقائية.
أما الشاب فوضع يده على فمه في حرج. ثم قال: "آسف. يبدو أنني أخطأت في حقك. سأرد لك النقود." ولما رأى علامات الدهشة على وجه شرايبر ابتسم في خجل ورفع سبابته في حركة خاطفة مشيرا إلى الفراغ فوقه.
قضب شرايبر حاجبيه ولم يعرف ما يقول. لحظة ذهول ومرت ثم زاده تصرف الشاب غضبا واشتعالا. كان يداعبه إذن! وكيف يجرؤ على مثل هذا الهراء السخيف؟ ياله من كلب واطئ! لن أعود إلى هذا المكان ما حييت!
وفي لحظة حسم أمره وترك المكان بخطى ثابتة دون أن ينظر خلفة ولو مرة واحدة. كاد يعدل عن عزمه عندما انطلق دوي الإنذار مرة أخرى فهم بالاستدارة للاستخبار عما طرأ. لكنه شد على نفسه وعجل من خطوته. كسور ثانية اضافية وكان خارج المحل.
في يوم مشمس كهذا كان الله بين البشر، وحتما سيعود. وكان الناس حينها يمشون في نشوة وذهول ويحييون بعضهم البعض بأن يقول أحدهم: "ربنا موجود"، فيبتسم الآخر ويرد: "حقا، إنه موجود، لم يعد لدي أدنى شك في ذلك." حتى السيد شرايبر، أكيد لن يبقى على صممه إلى الأبد.
الثلاثاء، أبريل ١٩، ٢٠١١
بورنو
"مفيش حاجة بتحصل في البلد دي" قالها سام وهو يرفع زجاجة البيرة إلى فمه ويأخذ رشفة طويلة.
هذه هي اللحظة التي كنت أنتظرها. تتكرر كل يوم. قلت: "سكووووت!" ابتسمت بخباثة، نظرت إلى سام ثم إلى مو ثم قلت: "أنا هامثل في فيلم بورنو"
"أفندم؟"
"أيوة، إنهاردة قابلت الزعيم وطلب مني أجيلوا الإستوديو بكرة!"
الزعيم هو لقب شاب من شبان الحارة، يقولون عنه أنه على صلة قوية بالمافيا اللبنانية والمافيا الروسية. رغم أن شكله لا يوحي بذلك إطلاقا. تجده دائما جالسا على القهوة على ناصية الشارع الرئيسي، وحوله سرب من أصحاب المصالح والعواطلجية أمثالي. يتوددون إليه، يأمرهم بمهمات صغيرة كشراء علبة سجائر أو جريدة من الكشك على الجهة المقابلة للشارع. يأملون طبعا أن يتوسط لهم عند معارفه ليحصلون على وظفيفة ك...، لا أعرف، كسعاة لتجار الحشيش يحومون حول المحطة الرئيسية ويصطادون الزبائن، أو كحراس أبواب للملاهي الليلية في الحي المجاور.
خجلي وثقتي المهتزة بنفسي لم يسمحا لي بالذهاب إلى الزعيم ومحاولة اقتناص نصيبي من الكعكة. كنت أقول لنفسي: "أنت أقبح شبان الحارة. كل أصدقائك يأكدون ذلك. سيبصق الزعيم عليك ويلعن آباءك إن حاولت الاقتراب منه." لذا كل ما كنت أفعله هو أن أجلس على مقربة منه على القهوة أتابع ما يجري بعيون جائعة، وعندما يتنبه إلي وأحس أنه يرمقني بنظرة متعالية أغض البصر وأقلب في كوب الشاي الموضوع أمامي بانفعال.
إلى أن جاء ذلك اليوم، يبدو أن مزاجه كان صافيا على غير العادة، إذ وجدته ينادي عاي: "إنت يا وله، أيوة إنت يا قرد، مالك قاعد هناك كده ليه زي الأهبل؟" قلت: "سوري، موش قصدي، أصل أنا خالي شغل." عندما سمعني أتكلم، عقد الزعيم حاجبيه ونظر إلي نظرة فاحصة. ابتسمت بداخلي. لقد اعتدت هذه النوعية من ردود الأفعال. صوتي هو أفضل ما في، صوت ذكوري رخيم، وكثيرا ما ينصعق الناس وتنفجر ملامح وجوههم دهشة عندما يسمعوه. لا لأنه يتعارض تماما مع جسدي الهزيل ووجهي الذي يشبه وجه الضفضعة، بل أعتقد لأن لا أحد ينتبه إلى وجودي أصلا قبل أن أفتح فمي لأتكلم.
ثم حكيت لسام كيف عرض علي الزعيم أن أشارك في أحد أفلام البورنو التي يقوم بإنتاجها. قال حينها: "إوعى تكون بتتكسف يا واد" ضحكت خجلا وانفعالا عندما تذكرت هذه الجملة، وضحك سام معي. "تخيل يا سام، أنا إللي عمري ما نكت في حياتي هانيك واحدة من بتوع الأفلام دول. واو." اكفهر وجه سام فجأة وقال: "لو منك لا أعيش في الوهم يا مان. هي بس هاتشوف وشك وهاتتف عليك." تدخل مو بانفعال: "يخرب بيتك إنت موش هتبطل تهبط من معنويات الواد كدة، أصدقاء آخر زمن! وبعدين أنا سمعت إن إحصائيا أغلبية النسوان بيختاروا الراجل على أساس صوته موش على أساس شكله!" مع ذلك أطرقت برأسي وغمغمت: "لأ. سام معاه حق. بلاش أحلم جامد لحسن آخد على دماغي."
في هذه اللحظة رن تليفوني المحمول. سمعت صوت نسائي غنج يقول "هاللو. أنا نادين إللي هاعمل معاك الفيلم بكرة. حبيت بس أسمع صوتك..." يبدو أن ما يقال صحيح مائة بالمائة من أن الإنسان في لحظات الخطر يتدفق الأدرينالين في عروقه ويتحول إلى وحش كاسر. على غير عادتي وجدت نفسي أقول: "ممم صوتك مهيج جدا يا جميل. قمال شكلك هيبقى عامل إزاي. مش قادر أستنى لحد بكرة." سمعتها تبعد التليفون عن فمها وتوشوش شخصا ما يقف إلى جانبها، كلام لم أفهم منه إلا أنها كانت تمدح في صوتي وكم هو قوي وجميل.
في اليوم التالي ذهبت إلى الاستوديو في الميعاد المتفق عليه. صعدت بالأسانسير إلى الطابق العاشر في بناية رمادية لا تبوح على الإطلاق عما يجري بداخلها. وجدتها في غرفة الانتظار تدخن سيجارة. عقدت حاجبيها ونظرت إلي، ثم نظرت إلى الحائط. وضعت ساق عارية فوق الأخرى وحاولت أنا أن أختلس نظرة إلى ما بين ساقيها تحت التنورة القصيرة. تنحنحت وقلت: "مساء الخير." نظرت إلى مندهشة وقالت: "موش معقولة، تخيلت شكلك مختلف تماما." لم اعرف ماذا أقول، لذا قلت: "وأنا كمان اتخيلتك مختلفة تماما." صمتنا. أشعلت سيجارة أخرى.
للحق لم تكن جميلة إلى هذه الدرجة. مر أكثر من عشرين دقيقة قبل أن يدخل الزعيم ويقودنا إلى غرفة أخرى لنبدأ شغلنا – وفي هذه الدقائق العشرين كنت أختلس النظرات إليها، أتحسس جسدها من بوز جزمتها إلى مفرق شعرها. صرت أقل انفعالا مع كل دقيقة مرت وأكثر قدرة على رؤية الأمور على حقيقتها. قدرت سنها بحوالي أربعين عاما، إحدى هؤلاء النساء العاديات في منتصف العمراللات أرى منهن المئات يوميا في الشارع وفي المواصلات العامة وخلف الخزنة في السوبر ماركت وعند الخباز وفي صالونات الحلاقة والصيدليات وأكشاك السجائر. على وجهها علامات القهر وفي عينيها نظرة حزن غير قابلة للتفاوض. كان يمكن أن تكون أما لأحد أصدقائي.
جاء الزعيم وساقنا عبر ممر صغير، كان يضحك ضحكته المتقطعة المتحشرجة المألوفة، فتح لنا الباب وقال بنبرة ساخرة "خشوا برجليكوا اليمين" ثم "أهلا بيكوا في المعمل بتاعي". لن أبالغ إن قلت أنني قضيت تسعة وتسعين بالمائة من الأربعة وعشرين ساعة الماضية محاولا تخيل هذه اللحظة وما سيتبعها من لحظات. وبالتأكيد جزء كبير من الوقت كان مخصصا للغرفة التي ستكون هي مسرح الحدث. هل سيكون السرير سرير ماء مستدير مفروش بملائة حمراء كما نراه في الأفلام؟ أم أن الديكور سيكون أكثر واقعية؟ لست خبيرا بالسينما أو بالفنون بشكل عام لكن أتذكر أنني سمعت أحدهم يقول أن هناك اتجاه عام لتصوير الأشياء بواقعية أكثر، والبعد عن الخيال المفرط فيه.
لكن ما كان ينتظرني في "المعمل"، كان بالتأكيد أغرب من الخيال. كانت الغرفة صغيرة جدا وخالية تماما من الأثاث، عدى طاولة خشبية في أحد أركانها وفوقها شاشة تليفزيوية وجهاز فيديو، وعلى حافة الطاولة ميكروفونان وأمام كل واحد منهما كرسي خشبي بسيط. سمعت الزعيم يضحك من خلفي ضحكة مجلجلة. التفت إليه فوجدته يرمقني بنظرة مستهزئة وقال: "تكنش فاكر إنك كنت هاتنيك بجد. هاها. إحنا ناس محترمة يا أستاذ. الأمريكان يصوروا ويفجروا زي ما هم عايزين. إحنا ما عندناش الكلام ده. إحنا نعمل الدوبلاج بلغتنا بس. يالله شوفوا شغلكوا."
قبل أن يخرج ويرزع الباب وراءه، دس الزعيم في يد كل واحد منا ورقة عليها الجزء الخاص به من الحوار. ثم ضغط على الأزرار الخاصة بتشغيل التليفزيون والفيديو. الفيلم كان يحكي قصة شاب يذهب إلى بيت صديقه فيجد نفسه وحيدا مع أم ذلك الشاب. وبعد تلميحات وإيمائات ولمسات غير مقصودة يمارسان الجنس سويا.
تعلثمت كثيرا أثناء قراءة النص، خاصة عندما وصلنا إلى المشهد الجنسي. كنت بالكاد تمكنت من هضم المفاجأة الأولى لأجد هذه المفاجأة في انتظاري – ميكروفون وطاولة خشبية بدلا من السرير الأحمر المائي! ومن كان يتخيل أنني سأفقد عذريتي وأبدأ مشواري كعنتر زمانه على هذه الطريقة السيريالية؟ ضحكت في نفسي وهززت رأسي وأنا أصدر بعض التآوهات الحذرة تماشيا مع ما يحدث أمامي على الشاشة. نعم، هذه هي حياتي، صوت فقط، بلا صورة. ثم نظرت إلى نادين فوجدتها قد أغلقت عينيها وانهمكت تماما في ارتجال التآوهات مع بعض الكلمات القبيحة المتناثرة هنا وهناك. يا ترى ماذا يدور في ذهنها الآن، وإلي أي فراش ستسافر بخيالها؟
الثلاثاء، فبراير ٠٨، ٢٠١١
الثورة الحقيقية

مكان التجمع: ميدان التحرير. وأين؟ عند أحد عواميد الكهرباء.
أعادت الأحداث المصرية الأخيرة إلى الساحة السياسية والإعلامية مصطلحات حسبناها ذهبت أدراج الرياح، كالكلام عن الثورة وإرادة الشعب وغيرها من الشعارات التي يرن فيها صدى الحرب الباردة ولم تكن قد وجدت لنفسها حيزا في عالم العولمة وهيمنة الرأسمالية الجديدة. كما أن الكثيرون يعتبرونها عاطفية وساذجة بشكل زائد عن اللزوم.
إلا أن الحاضر في ميدان التحرير يستشعر أن شيئا ما في مصر تغير بالفعل بشكل جذري - وبغض عن النظر عن المكاسب أو المخاسر السياسية التي ستتمخض عنها أحداث هذه الأيام. ولعل أكثر المشاهد تعبيرا عن ذلك التجمعات الليلية حول عواميد الإضاءة في الميدان، وهي المصدر شبه الوحيد للكهرباء بالنسبة للمعتصمين.
بدءا ذي بدء أحسب القول جائزا بأن التليفون المحمول هو السلاح الرئيسي في أيدي المعتصمين، إذ تعتمد "الثورة" اعتمادا حيويا على الاتصال المستمر بوسائل الإعلام الدولية، وذلك لمواجهة حملات التضليل المعلوماتي التي تشنها وسائل الإعلام الرسمية على المواطنين خارج الميدان، لتسحب بذلك بساط التأييد من تحت المتظاهرين. وبما أن الهواتف النقالة بحاجة إلى شحن دوري لبطارياتها، فإن تأمين مصادر للكهرباء في الميدان أصبح من الهواجس الحيوية، خاصة وأن غالبية المباني والمحلات والمطاعم المطلة على الميدان إما مغلقة أو احترقت جراء أحداث العنف يوم الجمعة 28 يناير.
فما كان من المعتصمين إلا أن لجئوا إلى سحب الكهرباء من عواميد النور التي تضيء الميدان ليلا. فصارت أماكن لتجمع المتظاهرين على اختلاف أطيافهم، يلتفون حول موزع للكهرباء سلكه مغروس في أحشاء العامود ويتناوبون على إعادة الحياة إلى هواتفهم. وأصبحت جمل ك"حد معاه شاحن؟" و"عندكوا فيشة فاضية؟" من الأكثر ترددا في الميدان.

"مبارك دمر حياتي"، هكذا يقول محمد محمود محدثا شابا من أبناء الطبقة الغنية، أبيض البشرة أنيق الهندام، ينصت باهتمام ويهز رأسه موافقة بين الفينة والأخرى. الإثنان يجلسان مقرفصين بجانب أحد عواميد الكهرباء بالجزيرة الحجرية – أو الكعكة الحجرية كما يسميها المصريون - التي تتوسط ميدان التحرير. يحملان العلامات المألوفة التي أصبحت بمثابة زي رسمي للقابعين هنا: قطعة من القطن مثبتة بشريط لاصق على الجبين تضمد جروحا أصيبا بها جراء تراشق المتظاهرين بالحجارة مع فرق البلطجية وغيرهم من مؤيدي النظام. ورذاذ من أوراق الحشيش الأصفر الجاف جمعها جسداهما استلقاء وقرفصة في حدائق الميدان. وأخيرا وجه يرتدي حالة ما بين الإرهاق والنشوة والشديدين.
قصة محمد التي يلخصها بتلك الجملة "مبارك دمر حياتي"، والتي قد لا تختلف بالنسبة للبعض عن مفاهيم كالثورة وإرادة الشعب فيما تحمله من نبرة عاطفية تميل نحو المبالغة، تلك القصة نموذجية تعطي تصورا عن خلفية الكثيرين من الموجيدين بالميدان، وفي نفس الوقت تكدس العناصر المألوفة بشكل قد يجعلها تبدو أقرب من الخيال.
محمد رجل في منتصف الثلاثينات، حاصل على شهادة الابتدائية، متزوج وله بنت ويعيش مع اسرته في بيت حماته نظرا لصعوبة الحصول على مسكن منفصل. هو رجل هادئ الملامح، وديع الطباع، حتى أن صوته يخلو من "البحة" التي تصاحب الكثير من المتظاهرين جراء هتافهم المتواصل بشعارات اسقاط النظام. يقول: "الموضوع بدأ بمسألة تافهة، بدأ بباقة من الخس." لكن "يوم الغضب" كما أطلق عليه المتظاهرين، وهو يوم الجمعة 28 يناير، ما لبث أن غير حياته بأكملها، فانتهى به مطلقا وتاركا منزله بلا رجعة ومعتصما في ميدان التحرير لستة أيام متواصلة.
كان قد سمع بالمظاهرات التي خرجت إلى الشوارع يوم الثلاثاء 25 يناير، لكنه لم يعرها اهتماما خاصا. وفي صباح يوم الجمعة 28 سأل زوجته "لماذا لا تعدين طبقا من السلطة لابنتنا بباقة الخس التي اشتريتها؟" اشتراها منذ حوالي اسبوع، وكان يعيد عليها السؤال ذاته كل بضع أيام لكنها كانت تتجاهله، فيضرب كفا على كف ويقول "حسبي الله ونعم الوكيل."
ثم بعد قليل تقول (كعادتها): "لقد نفذ مصروف البيت." فيقول: "كيف؟ باقى أكثر من إسبوع على انتهاء الشهر!" يعطيها مصروفا سخيا رغم أجره الذي لا يتعدى الثلاثين جنيها يوميا، أي أن الأسرة فعليا تعيش تحت خط الفقر. لكن يشك منذ فترة أنها تختزن من المصروف وتعطي لأمها دون علمه. رغم ذلك يضغط على أسنانه وينزل إلى السوق ويشترى بعض الأغراض، لكنه لا يشتري خسا. وعندما يعود ويفتح الثلاجة ليرص فيها المشتريات يرى باقة الخس وقد بدأت تذبل، فيسألها، كاظما غيظه: "لماذا لا تعدين طبقا من السلطة لابنتنا بباقة الخس التي اشتريتها؟" فتنفخ وتقول: "حاضر."

بالنسبة للكثير من المعتصمين في الميدان ليست المطالب السياسية التي نزلت بهم إلى الشارع وحثتهم على الصمود وعدم فض اعتصامهم. بل هو فيضان الكيل وانفجار الغضب المكبوت. وبالتالي فإن النظر إلى الإعتصام والمظاهرات المليونية على أنها استراتيجية متبعة لاغتنام عدد من المكاسب السياسية لا يعطي للأحداث كامل حقها. فما يحدث في مصر الآن هو قبل كل شئ تعبير شعبوي ضخم عن اليأس والغبن المخزن، واللذان في ذروتهما لا يجدان مخرجا سوي فصل جميع السلوك وإيقاف ماكينة الحياة عن العمل تماما.
حد الجالسين في الحلقة عند عامود الإضاءة يقطع كلام محمود، ليرمي على الموجودين إحدى نكاته الفجة. يضحك الآخرون ثم يحاولون إسكاته ليتمم محمد كلامه - لكن لا رغبة هنا أقوى من الرغبة في الكلام والتنفيس عن الذات. أما صاحب المداخلة فهو شريف زينهم، وهو على حد وصفه لنفسه "صايع". وبالفعل فإن فمه نصف الشاغر دوما، شفته السفلية الضخمة وصفي أسنانه المهشمان قد يوحوا للبعض بشئ من الخبث وسوء النية. يتحدث بطريقة استعراضية ويلوح ويطيح ويشير بيديه للزيادة من وقع كلامه على المستمعين. يقول أحدهم مستهزئا:"انت شارب حاجة يله؟" فيرد: "بصراحة بلعت حبة ترامادول (مخدر قوي) ومزاجي عالي جدا!"
وماذا جاء به إلى الميدان؟ كان ذلك في "يوم الغضب." وكانت النفوس مضغوطة كانبوبة غاز قابل للاشتعال، وكفتها شرارة صغيرة وانفجرت. يخرج شريف من جيبه ورقة يقول إنها إثبات الإخلاء من خدمة الجيش. ثم يشير إلى خانة خالية في أسفلها ويضيف، عاقدا حاجبيه: "لم يكن ينقصني إلا إمضاء شيخ الحارة في هذه الخانة لأكون قد أنهيت خدمتي. لكنه رفض الإمضاء إلا مقابل مبلغ كبير من الرشوة لم أقدر على دفعه!"
خرج من بيت الشيخ لاعنا أبويه وشجرة أسلافه إلى آدم أبو البشر. ثم قذف بحبة مخدرة في فمه "لتضبيط الدماغ" وقرر التنزه في الشارع لتهدأة أعصابه. فلم يفق على نفسه إلا وهو واقف وسط حشود من المتظاهرين يحاولون اقتحام ميدان التحرير، وعناصر الشرطة تحاول تفريقهم بقنابل الغاز ورشاشات المياه والعصيان والرصاص الحي والمطاطي.
يقول "المتاتي" وليس "المطاطي" كعادة سكان الأحياء الشعبية. ومرة أخرى تتدخل يداه لتدعم كلامه، فيرفع قميصه ليكشف عن جسد تناثرت عليه البقع السوداء حيث أصيب بالرصاص واخترق جسده ليستقر تحت جلده. يسأله أحدهم: "لماذا لم تستعن بأحد الأطباء لإخراجه من جسدك؟" يقول ثاغرا فيه عن ابتسامة "صايعة" بحق: "لا، سأحتفظ به كتذكار."
و الشرارة التي فجرت الغضب في نفس محمد محمود؟ كانت باقة من أوراق الخس. أما الروافد التي أدت إلى هذه الحالة فهي تكاد تكون لا تحصى. تبدأ برفض صرف المعونة الحكومية للأم بعد وفاة الأب، وعندما ذهب للاستفسار عن السبب قالت الموظفة المختصة: "لا تستحق." يهز رأسه آسفا ويردد "لا تستحق... أم لسبعة أولاد يعيشون في غرفة واحدة. ويقولون لا تستحق." وتنتهي بالتخلي عنه كعامل دهان في المؤسسات التابعة للجيش، بعد اعتراضه على اختلاس بعض رؤسائه من الضباط للأموال.
وفي ذلك اليوم، يوم الجمعة 28 يناير، ذهب إلى الصالون فوجد الحماة تجلس جلستها المعتادة، رجل مضمومة إلى صدرها، والأخرى تتدلى من الكنبة الكبيرة. تبدو كسلطان زمانها على رأس ديوانها تنتظر قدوم الوزراء والسفراء والحكماء. ووقعت عيناه على باقة الخس في يدها، تنزع منها الورقة تلو الأخرى وتغرسها في فمها ليعلو صوت ماكينة أسنانها تهشمها. يحدق فيها غير مصدق ثم يقول: "لكن الخساية كانت للبنت." "تنظر إليه بتعالي وتقول: "خساية إيه يابو خساية."
لم يفقد أعصابه، لم يصرخ ويهدد ويشتم. فقط أدار ظهره وتحرك صوب الباب. وعندما جرت زوجته للحاق به ألقى عليها نظرة مستهزئة من فوق كتفه وقال: "أنت طالق." ولم يعد إلى بيته من حينها.
يمد الشاب الأنيق يده يمسح بها على كتف محمد مطمئنا. ينظر إليه الآخر ثم يغلق عينيه ويهز رأسه. بعد قليل يقول: "على فكرة لم أكن أتخيل أنه سيأتي اليوم الذي أجلس فيه هكذا مع أبناء الباشاوات كواحد منهم، نشارك بعضنا البعض الهموم والأكل ومكان المبيت."
مصر تغيرت، ولن تعود أبدا كما كانت.
الأربعاء، أكتوبر ٠٧، ٢٠٠٩
للقدس أبواب

تحكي لي كيف جائت إلى إسرائيل. دفعوا لها ثمن تذكرة الطائرة ورسوم الجامعة. قلت لها يبدو أنني سأبدأ في التنقيب عن أصول يهودية لعائلتي ثم أتقدم بطلب الحصول على جنسية اسرائيلية – لأتمتع بكل هذه المزايا.
كانت يوما ما متدينة. تلتزم بقواعد الحشمة وتستر العورة. أكمام البلوزة تغطي الذراع من الكتف إلى ما بعد الكوع. التنورة تحت الركبة، وباقى الساق تغطيها جوارب نايلون داكنة. الألوان تتراوح ما بين البني والبيج والأسود. بعد أن تزوجت داني لملمت شعرها كذلك تحت قطعة قماش.
تدخل المدينة القديمة من باب صهيون الغربي. تمسح بيدها على الميزوزا الحديدة الصغيرة المثبتة على الباب ثم تقبلها، وتتذكر قول الرب: "ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك وقصّها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك ومتى أتى بك الرب الهك الى الارض التي حلف لآبائك ابراهيم واسحق ويعقوب ان يعطيك.الى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وآبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها واكلت وشبعت فاحترز لئلا تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية." تستمر في طريقها إلى حائط المبكى، مرورا بشارع باتيي ماخاز وشارع مزجاف لاداخ. تعرف أن هناك شوارع من المستحسن ألا تدخلها. تلوح لها من طرف عينها وهي تمشي كبقع ألوان مفرقعة وأصوات وروائح. هناك قانون يمنع البناء في القدس الغربية كلها بغير حجر المدينة القديمة الجيرى. لذا ذلك الجزء من المدينة يغلب عليه اللون الأصفر.
للقدس أبواب وإسرائيل كذلك لها مداخل عدة! ثم ليس فقط مهما من أين تدخل، بل أيضا من أين تأتي! كأني جسد مغناطيسي يلتقط شظايا الأماكن التي يخترقها فتظل عالقة به.
أن تهبط إلى إسرائيل من الجو غير أن تزحف عليها برا. في زيارتي الأخيرة جئت من أوروبا ونزلت في واحة أوروبية صغيرة في الشرق الأوسط – فلم يلتقط عدادي الثقافي السايسموغرافي أي اضطرابات! ولعل هذا هو ما جعلني أستهين بأوجه الخلاف بين اسرائيل ومصر تحديدا. فلا توجد بين البلدين ملفات عسكرية مفتوحة. لماذا إذا غالبية المصريين– والمثقفون بالذات – مستمرين في مقاطعة إسرائيل؟ أهو مزيج من الإرث الناصري وكراهية الإسلاميين المبالغ فيها لليهود؟ وكلها أيديولوجيات تستخدم اليهودي والإسرائيلي كآخرِها، وبدونه لم تكن لتتمكن من صياغة هوية واضحة. أم أن في المقاطعة عنصر تكتيكي – استخدامها كوسيلة ضغط على اسرائيل كي تمضي قدما في عملية السلام؟ وهل اسرائيل تبالي حقا بعلاقاتها بجيرانها؟ أكثر مما تبالي بمصالح مستوطنيها ومصادر مياهها؟
هذه المرة عبرت الحدود عند طابا. ركتب الباص من القاهرة الساعة العاشرة مساءا. نصل والفجر يشقشق. سكون سحري/مرعب يخيم على صحراء سيناء. أنزل وأرتجل الكيلومتر الأخير إلى المعبر. طابا مدينة أشباح. احساس أقرب إلى الذعر سيعاودني مرارا أثناء رحلتي. احتجت إلى بعض الوقت لأفك شفرته. عندما تتكون لديك صورة واضحة لشئ ما – وتتضخم بشكل سرطاني بفعل سنوات من عدم الاقتراب. الصورة والواقع لبضعهما كطرفي مقص!
أنظر حولي برهبة شديدة وأردد في ذهني ما أرى كما لو كنت أدونه. صحراء. جبال. مبنى زجاجي كبير على الناحية المصرية. عائلات عربية كثيرة، الأمهات محجبات وبدينات. معهم طبعا أمتعة كثيرة. أعرف لماذا أحملق هكذا في الأشياء. لكنني لن أجد ما أبحث عنه، لن أجد "إسرائيل" في الجبال وبالتأكيد لن أجدها في وجوه الناس. في خلفية رأسي صوت يحاول أن يحل الأزمة ويردد، كما لو كان يضع ملصقات على الأشياء: "لاتنسي، هذه إسرائيل المخيفة". جزء يرى ويسجل ويسمع، وجزء يقف له بالمرصاد، كأنه يخشى أن ينفلت من قبو الذاكرة.
To be continued
الأحد، أغسطس ٢٤، ٢٠٠٨
"لأ. صحاب. فريندز. مش جيرلفريندز."
"هو مالو قلب برنامج حياتي كده ليه؟ يا موز: قوليلي بصراحة: إتبليتي شوية لما سمعتي صوتي؟"
ناديا تفتح عينيها عن آخرهما وتنظر إلى سمير، تصنع بيدها في الهواء كوب شاي وبالأخرى ملعقة تغرسها فيه، هي الإشارة المتفق عليها كي يحل أحدهما مكان الآخر بينما يستريح الأول قليلا. تستمر في الكلام مع المستمع وهي تتحرك
"إنت قاعد في الضلمة؟"
"ومش بس كده!"
"ومولع سيجارة؟"
"أومال!"
"آخر مرة حد زارك في البيت كان إمتى؟"
سمير وناديا يحرصان على أن تتم عملية انتقال السماعات من أحدهما إلى الآخر ثم جلوسه على كرسي المكتب الجلدي الضخم المترهل (الذي تبرع به والد سمير) خلف الميكروفون والشاشة بسلاسة ودونما إحداث أدنى صوت. العملية كلها من الإشارة إلى انتهاء التبادل لا تستغرق أكثر من بضع ثوان، ينطلق بعدها صوت سمير ليخض المستمع
"بخ! أنا قرصان الليل!"
توت توت توت. انقطع الاتصال.
يضحك سمير. "أوعى وشك. باين في حد هنا بيخاف من المواجهات السخنة!!"
"المهم: دلوقتى يا جماعة: شوية طراوة. شوية شقاوة. دلوقتي زي ما وعدناكوا أجدد أغنية لفرقة بانانا إيجيبت "عاوز تنيك لازم تنيك" رييييييييدي جوووو"
ربما ستحاول أن تنام قليلا. أول مرة يستمر فيها البث لكل هذه المدة. عيناها لم تر النوم منذ أكثر من سبعين ساعة. اختيار المخبأ كان موفقا فعلا هذه المرة. لكن القلق بدأ ينتابها. لم يتوقعوا نصرا مثل هذا. قبل اليوم لم يجرؤوا على أن يبثوا لأكثر من خمس ساعات متواصلة من نفس المكان، خوفا من أن تتمكن السلطات من تقفي أثرهم. انتابها الشك لبضعة لحظات في التفسير الذي طرحه حسين، أن "الحكومة ملهية بمليون بلوة أخرى!" ربما الغرور دفعك إلى التمادى أكثر من اللازم هذه المرة يا حسين. ربما نحن كلنا صرنا واثقين من أنفسنا بشكل زائد عن اللزوم. وماذا لو كنا بصدد الوقوع في فخ كبير؟
تترنح قليلا في طريقها إلى المطبخ. حسين يدخن سيجارة ويخرج الدخان من فمه ببطئ على هيئة دوائر. يترك كرسيه لتجلس في مكانه. يبدأ في تدليك عنقها. يقول "واحد من إياهم تاني؟" "لأ. ده مش بيرخم. ده أنا عارفاه. اتصل كذا مرة قبل كده" تتنهد وتقول "وحداني..." يقول "صعبان عليكي قوي كده يختى" ويزيد الضغط على عنقها حتى تصرخ وتفز من على كرسيها وتنهره "ناقصاك انت كمان!" ثم تقول "على فكرة بيتهيألى كفاية كدة النهاردة..." "ليه، مش هيوحشك سي زفت!" يخرج دخان سيجارته دفعة واحدة وكأنه يقذفها به. تشخر وتترك المطبخ.
…
…
"موز"
"أيوة يا عيوني"
"ما بعرفش أنام من غير ما أسمع صوتك في الراديو"
"عارفة"
الجمعة، يونيو ٠٢، ٢٠٠٦
صحيت النهاردة – والنهاردة يوم شغل في ألمانيا – ودني الشمال مسدودة. إفتكرت إني نسيت جرعتي اليومية (3 مرات). عندي إدمان لسماع الهتافات من مصر. بتجيلي سلعة مستوردة عن طريق تسجيلات القنوات وتسجيلات أصدقاء. بلزق ودني في السماعة وببقى كويس (نوعا ما). عندي شوق لسماع الأصوات على الأقل، أصوات الناس إللي أنا قلقان عليهم. لقيت عندي تسجيلات قديمة لعلاء (جرعة الصباح. زميلتي سمر في مصر بعتيتلي كلام سجلته مع شرقاوي يوم 25
كلمت الدكتورة منى مينا علشان أطمئن عليه. كلمت مالك علشان أسمع صوته (أخيرا) ويحكيلي. نفسي أتكلم مع بهاء
عندي رغبة لما أي حد يشتيكيلي من أي مشكلة أيا كانت إني أقوله: بص شوف الشباب في مصر عملوا إيه (وأعمل زيهم)! مش قادر أعبر قد إيه أنا سعيد وشاكر إني إتعرفت السنة إللي فاتت على بعض الناس من إللي هما معتقلين دلوقتي، وسهرت معاهم، وسمعت كلامهم. أو حتى شفتهم من بعيد. بأحس إن كل حاجة بيعملوها بتتكلم عن الصبر والتواضع و الإصرار وقبل أي حاجة: التفائل
مش عارف حياتي كانت هتبقى عاملة إزاي لو ما كنتش قابلتهم. والله أعلم هما جواهم حاسين بإيه دلوقتي
وزيهم منال وسلمى وناس كتيرتانية ساندت المعتقلين
حكيت الكلام ده مع فنجان قهوة للست صاحبة المطعم الصغير إللي محلها إتحبس جوا الكردون الأمني قدام الجامعة في مدينة بون. وأنا داخللها العسكري قاللي رايح فين. قولتله صحافة وكشرت في وشه وقولتله متضحكش كده
قاللي طب إتفضل. يخرب بيتك دانت لاتيف خالص
لإن الإدمان يحتم زيادة الجرعة باستمرار. رافقت طلبة ألمان الأمن بيضربهم قدام الجامعة. عملوا مظاهرات لإن الجامعة عاوزة ترفع تكاليف الدراسة. بيهتفوا بالفرنساوي إستشهادا بإللي حصل في فرنسا في الشهور الأخيرة. قرروا يقتحموا المبني إللي مجلس الجامعة كان هينعقد فيه عشان يقر زيادة الرسوم. ويعملولهم إعتصام عشان المجلس ميعرفش ينعقد. الأمن حواطلهم مداخل الجامعة. قالوا الطلبة هانمنع نواب المجلس من الدخول. الأمن ساعد بعض النواب على الدخول بالقوة وضرب الطلبة إللي عملوا حيطة قدامهم. مش ضرب مبرح يعني. إتكلمت مع واحد من الطلبة (إسمه "تيل") قاللي إن الطلبة قرروا التصعيد عشان بيشتكوا ويتظاهروا من سنة ومحدش مهتم. وقاللي إن الغريبة إنه من ساعة ما الأمن بقى يضرب ويعور ناس، من ساعتها حماسهم زاد، والمشاركين زادوا. قولتلوا دي غريبة فعلا عشان فيه واحد إسمه شرقاوي قاللي نفس الكلام ده قبل كده
المجلس ماعرفش ينعقد فنقلوا الجلسة إلى مكان سري بعض إصدار تعليمات لكل نائب إنه يقف على ناصية معينة في منطقة الجامعة (وزميله على ناصية غيرها وهكذا) لحد ما تيجي عربية تاخد كل واحد للمكان إللي النواب نفسهم ماكانوش يعرفوه. نفس السيناريو الجاسوسي حصل من كذا إسبوع في مدينة كولونيا، لكن قبلها كانوا الطلبة قدروا يعتصموا في الجامعة 11 يوم ويأجلوا إنعقاد المجلس. في النهاية أقروا زيادة الرسوم في المدينتين (وغيرهم للأسف). قولت ل"تيل" إني مستغرب ليه إللي بيحصل في ألمانيا، وإللي بيحصل في مصر وفرنسا والمغرب وإلخ ماطفحش على بعضه لحد دلوقتي عشان الصوت يبقى مسموع بجد. قاللي "قريب". إفتكرت مقال نورا و ضفت على "قريب" كلمتين كمان: ولسه ياما ياما
الألمان ساعات بيقولوا كلام كويس. عاوز أستشهد بيوشكا فيشر: لا مؤاخذة يا ريس - سيادتك إبن وسخة
(هاحاول أضيف التسجيلات بعد كده لو لاقيت حد يفهمني إزاي)
الجمعة، سبتمبر ٠٩، ٢٠٠٥

We might not be able to smash this picture in one go, but we can gnaw at it and eat and rip and blow and push and pull and spit and scratch and piss on it and tear - until it breaks!
نزار سمك

كنت فرحان بالحركة اللي حصلت في البلد يوم 7، مظاهرة هايلة، مراقبة على الانتخابات رغم كل الموانع... لكن فيه خبر كئبني و نساني الكلام ده كله. و اكتئبت أكتر لإن الخبر كان معروف من يومين و ضاع مني أنا على الأقل في هوجة الانتخابات و اليوم الفاصل إلخ إلخ...
النهاردة عم نجم كاتب في عاموده في جرنال المصري اليوم كاتب بيرثي نزار سمك. راح مع اللي راحو في الحريقة المؤسفة في بني سويف. نزار سمك؟! مش معقولة! انا كنت قرأت عن الحادثة سريعا واقلب و ارجع لمبارك و التجاوزات و المراقبين و مجلس الدولة... نزار سمك؟! أنا كنت أعرف الراجل ده! مبقيتش عارف راسي من رجليا. كل اللي شفته و عملته في اليومين اللي فاتوا انسحبت عنه الأضواء المسرحية في ثواني، بعد ما كان بيتفشخر في عين خيالي قدام الجماهير. طز في الانتخابات! طز لما يكون الراجل ده راح في حادثة! و الموضوع حصل وانا ولا هنا، علشان دايما بدور على الطرقعة
و الحدث الكبير
نزار سمك زي ما عرفته – و معرفتي بيه كانت ضئيلة لكن احترمته في دقايق – معتقدش إنه كان هيجري ورا المعمعة على حساب حدث زي ده يمكن يكون أصغر، لكن له ثقل برضه. مش هانسى حواري معاه عن شغله كمسرحي مع وزارة الثقافة، و عن رحلاته في مصر كلها سعيا لإحياء المسرح في ريف مصر و عموما المناطق خارج العاصمة. مع العلم إنه كان نضالي قديم. لذلك استغربت من الراجل ده بتاع انتفاضة السبعينات الطلابية اللي بيشتغل مع الحكومة و بيشحطط نفسه في البادية. يمكن مافهمتوش غير النهاردة، لما اقتنعت إن فيه زلازل بتحصل قدام كاميرات العالم و على مسارح السياسة الفخمة، في حين إن فيه حاجات أهم بكتير ممكن تكون بتحصل على مسرح صغير في بني سويف...
Archives
أغسطس 2005 سبتمبر 2005 يونيو 2006 أغسطس 2008 أكتوبر 2009 فبراير 2011 أبريل 2011 يوليو 2011